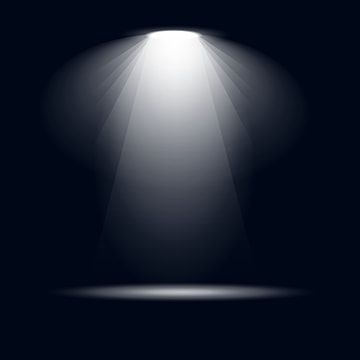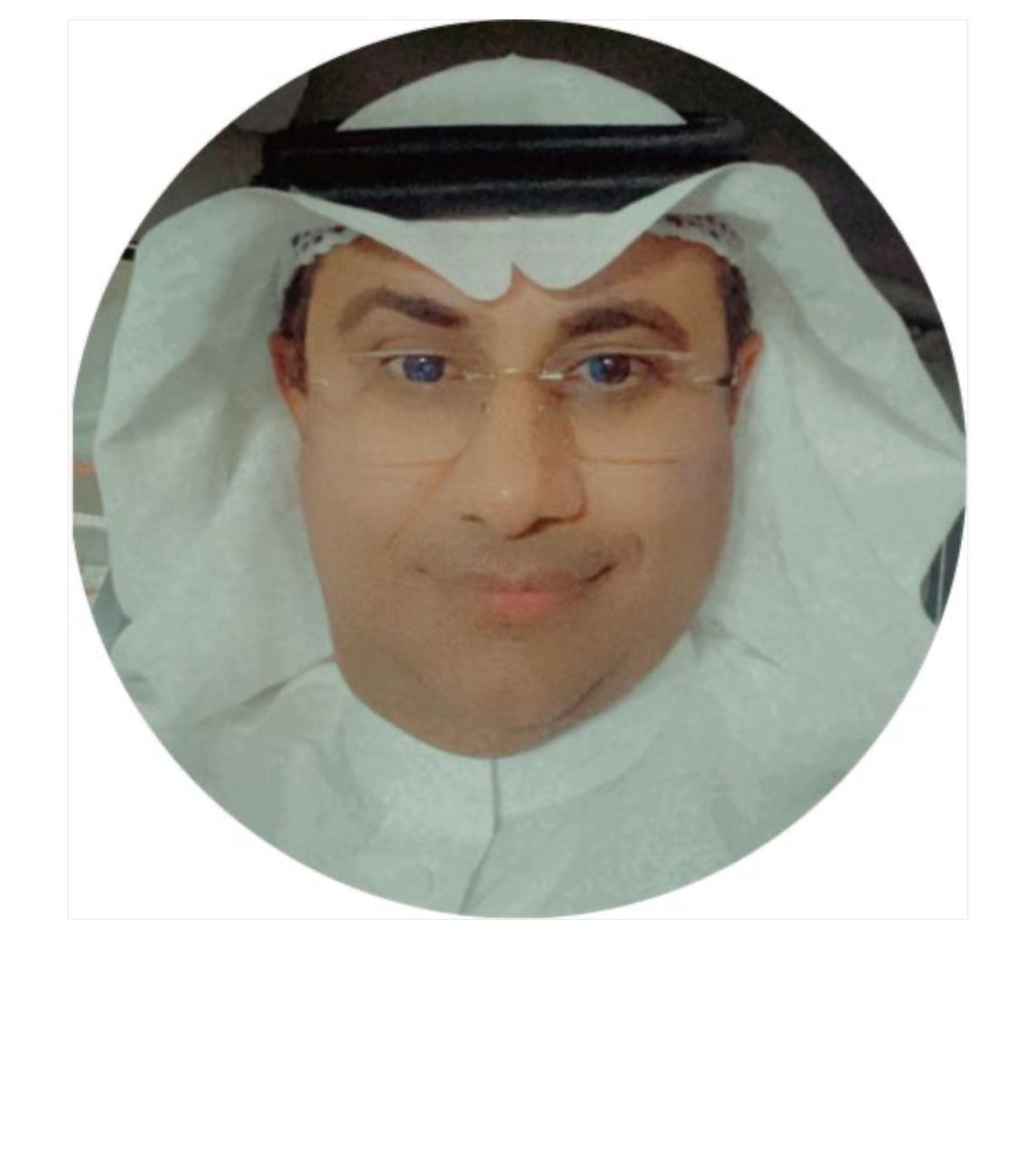الملتقى / شيخة سالم
ليست الهجرة النبوية مجرد لحظة تاريخية تُروى في كتب السيرة، بل هي مدرسة متكاملة تُعلّمنا كيف تُمزَج النبوة بالتدبير، والتوكل بالتخطيط، والصحبة بالصدق، والعزيمة بالحكمة.
في أوج التهديد، وبعد سنوات من التضييق والعداء من قريش، قرر النبي ﷺ أن يغادر مكة، لا هروبًا، بل انتقالًا إلى مرحلة جديدة من الرسالة. لم تكن الرحلة وليدة ارتجال، بل كانت محكمة التدبير، دقيقة التفاصيل.
أول ما نستوقف عنده في هذا الحدث الجليل هو الصحبة المختارة. لم يكن إلى جانب النبي ﷺ في هذه اللحظة الحاسمة إلا رجل واحد، اختاره لا لغناه، ولا لقوته، بل لإيمانه ووفائه، إنه الصدّيق أبو بكر رضي الله عنه، الذي ضرب أروع أمثلة الصداقة حين قال: «يا رسول الله، الصحبةَ الصحبةَ». في هذا الموقف تتجلى قيمة الصحبة الصالحة التي تُؤمَن عندها الأسرار، ويُشد بها الأزر، وتُقاسم بها المخاوف.
ثم يأتي التخطيط الاستراتيجي، فيختار النبي ﷺ أن يتجه جنوبًا لا شمالًا، إلى غار ثور، حيث يختبئ وصاحبه ثلاث ليالٍ، رغم أن المدينة تقع في الشمال. هذه الخطة المغايرة أربكت حسابات المشركين، فعميت عيونهم، وسُدّت أمامهم السبل.
ومع التخفي، جاء اختيار الدليل الأمين. لم يعتمد ﷺ على الطريق المعروفة، بل استأجر دليلًا محترفًا، عبد الله بن أريقط، رغم أنه لم يكن مسلمًا، لكنه كان صادقًا مأمونًا. وهنا نتعلم أن الكفاءة والصدق مقدمان على مجرد الانتماء، وأن الأمانة في العمل أساسٌ لا يُتنازل عنه.
ولم يكن الطريق إلى المدينة معبّدًا، بل كان محفوفًا بالمخاطر. ورغم ذلك، لم يظهر النبي ﷺ ولا صاحبه الخوف أو التردد، بل غمر قلبيهما يقين مطلق: "لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا". بهذه الكلمة، طمأن النبي ﷺ صاحبه، وربط قلبه بحبل السماء، فأنزل الله سكينته، وأحاطهما بجنود لم تُر، حتى أصبح الغار أعظم من قصر، لأنه ضمّ فيه النور، والصحبة، واليقين.
وصل النبي ﷺ إلى المدينة لا كلاجئ، بل كقائد مؤسس لحضارة، لأنه أحسن الاستعداد، واختار الرفيق الصادق، واستعان بالأمين، وأدار رحلته بصب
"هجرة النور: دروس في الصحبة والتخطيط من غارٍ صغير إلى أفقٍ كبير"
ليست الهجرة النبوية مجرد لحظة تاريخية تُروى في كتب السيرة، بل هي مدرسة متكاملة تُعلّمنا كيف تُمزَج النبوة بالتدبير، والتوكل بالتخطيط، والصحبة بالصدق، والعزيمة بالحكمة.
في أوج التهديد، وبعد سنوات من التضييق والعداء من قريش، قرر النبي ﷺ أن يغادر مكة، لا هروبًا، بل انتقالًا إلى مرحلة جديدة من الرسالة. لم تكن الرحلة وليدة ارتجال، بل كانت محكمة التدبير، دقيقة التفاصيل.
أول ما نستوقف عنده في هذا الحدث الجليل هو الصحبة المختارة. لم يكن إلى جانب النبي ﷺ في هذه اللحظة الحاسمة إلا رجل واحد، اختاره لا لغناه، ولا لقوته، بل لإيمانه ووفائه، إنه الصدّيق أبو بكر رضي الله عنه، الذي ضرب أروع أمثلة الصداقة حين قال: «يا رسول الله، الصحبةَ الصحبةَ». في هذا الموقف تتجلى قيمة الصحبة الصالحة التي تُؤمَن عندها الأسرار، ويُشد بها الأزر، وتُقاسم بها المخاوف.
ثم يأتي التخطيط الاستراتيجي، فيختار النبي ﷺ أن يتجه جنوبًا لا شمالًا، إلى غار ثور، حيث يختبئ وصاحبه ثلاث ليالٍ، رغم أن المدينة تقع في الشمال. هذه الخطة المغايرة أربكت حسابات المشركين، فعميت عيونهم، وسُدّت أمامهم السبل.
ومع التخفي، جاء اختيار الدليل الأمين. لم يعتمد ﷺ على الطريق المعروفة، بل استأجر دليلًا محترفًا، عبد الله بن أريقط، رغم أنه لم يكن مسلمًا، لكنه كان صادقًا مأمونًا. وهنا نتعلم أن الكفاءة والصدق مقدمان على مجرد الانتماء، وأن الأمانة في العمل أساسٌ لا يُتنازل عنه.
ولم يكن الطريق إلى المدينة معبّدًا، بل كان محفوفًا بالمخاطر. ورغم ذلك، لم يظهر النبي ﷺ ولا صاحبه الخوف أو التردد، بل غمر قلبيهما يقين مطلق: "لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا". بهذه الكلمة، طمأن النبي ﷺ صاحبه، وربط قلبه بحبل السماء، فأنزل الله سكينته، وأحاطهما بجنود لم تُر، حتى أصبح الغار أعظم من قصر، لأنه ضمّ فيه النور، والصحبة، واليقين.
وصل النبي ﷺ إلى المدينة لا كلاجئ، بل كقائد مؤسس لحضارة، لأنه أحسن الاستعداد، واختار الرفيق الصادق، واستعان بالأمين، وأدار رحلته بصبرٍ وإيمان.
الهجرة النبوية، بتفاصيلها الهادئة والعميقة، تعلمنا أن التوكل لا يلغي التخطيط، وأن المصاعب تُذلل بالإعداد، وأن الصداقة الحقيقية تظهر في الشدائد، وأن من جعل الله معه، فلن يضل الطريق.
فهل نقتدي به في رحلاتنا؟ وهل نخطط كما خطط؟ ونصاحب كما صاحب؟ تلك هي الهجرة التي ما زالت ترسم لنا معالم الطريق، من الغار إلى الأمل.